دعوة للفلسفة
كتاب مفقود لأرسطو! ضاع مع ما ضاع من المحاورات التي كتبها في شبابه ولم يبقَ منها غير أسمائها وبعض شذرات متفرقة منها. صحيح أن بعض المؤلفين القدامى قد عرفوا عنوانه الأصلي «بروتريبتيقوس»،٢ وأن عددًا منهم وضع كتبًا أخرى تحمل نفس العنوان الذي يفيد الحث على التفلسف وبيان ضرورته للحياة السعيدة، وصحيح أيضًا أنهم اقتبسوا منه عبارة ذاعت شهرتها في كتب الفلسفة حتى يومنا الحاضر؛ ألا وهي العبارة التي تقول: «إما أن التفلسف ضروري، ولا بد عندئذٍ من التفلسف، وإما أنه غير ضروري، ولا بد أيضًا من التفلسف لإثبات عدم ضرورته، وفي الحالين ينبغي التفلسف.»٣ولكن الكتاب ظل أكثر من ثلاثة وعشرين قرنًا في عِداد المفقودات، وبقي الأمر على هذه الحال منذ النصف الأخير من القرن الرابع قبل الميلاد حتى النصف الثاني من القرن التاسع عشر، حين نشر عالم ألماني كتابًا عن محاورات أرسطو طرح فيه السؤال عن مضمون الكتاب الضائع وهدفه، وانطلق البحث من هذا السؤال الحائر ودارت عجلته مائة سنة كاملة حتى أُعيد بناء الكتاب المفقود الذي تجده بين يديك.
•••
لو صرفنا النظر عن الفهارس القديمة التي أحصت مؤلفات المُعَلِّم الأَول٤ لوجدنا نصين اثنين من العصور القديمة يُذكر فيها «البروتريبتيقوس» الضائع ذِكرًا صريحًا؛ فالإسكندر الإفروديسي (حوالي سنة مائتين بعد الميلاد)، أكبر شُرَّاح أرسطو يقول:٥ إن أرسطو يطرح فيه السؤال عن ضرورة التفلسف لبلوغ السعادة والحياة الأخلاقية الطيبة أو عدم ضرورته، ويؤكد الإسكندر أنه قدَّم الدليل على ضرورته عندما بيَّن أن من يحتج على الفلسفة إنما يُثبت بهذه الحجة نفسه أنه يتفلسف، ولقد كان همُّ أرسطو أن يدافع عن صحة العبارة التي ذكرها أفلاطون في محاورة «الدفاع» على لسان سقراط:٦ «إن الحياة الخالية من البحث والتأمل حياة لا تليق بالإنسان، وأن يؤديها بحجج أخرى استمدها من تجربته في الحياة ورؤيته لها.» أما النص الآخر الذي يَرِد فيه ذكر الكتاب فيرجع إلى زينون مؤسس الرواقية (من حوالي ٣٣٦ إلى ٢٦٤ق.م) الذي يروي٧ عن مُعلمه الكلبي «كراتيس» (أو أقراطيس تلميذ ديوجينيس الكلبي) أنه كان يجلس يومًا في دكان صديقه الإسكافي «فليسكوس»، وأخذ كراتيس يقرأ عليه من كتاب أرسطو «البروتريبتيقوس» الذي أهداه لثيميسون ملك قبرص وقال له فيه: «ما من أحد مثلك أهَّلته الظروف ليَهَبَ حياته للفلسفة؛ فأنت ثري، ويمكنك أن تُنفق المال اللازم لتحصيلها، وأنت مرموق المكانة.» كان الإسكافي يستمع لما يقرؤه صديقه عليه دون أن يكفَّ عن مواصلة عمله، فقال له كراتيس: «أعتقد يا عزيزي فليسكوس أنني سأهديك كتابًا بنفس العنوان، فإنك في رأيي أهل للحياة الفلسفية أكثر من ذلك الذي أهداه أرسطو كتابه.»
وسواءٌ أكانت حكاية الفيلسوف الكلبي صادقة أم من نسج خياله، فإن مغزاها لا يخفى على القارئ. لقد أراد هذا الشحاذ البائس — الذي عرفت العصور القديمة جولاته في القرى ومواعظه للفقراء بالزهد والعودة إلى حياة الطبيعة — أراد أن يقول: إن الإسكافي المسكين أقدر على الحياة الفلسفية من الملك صاحب السلطة والجاه والثراء. والأهم من ذلك أنه لم يكن ليروي الحكاية ولم يكن زينون ليرددها بعده لو لم يكن «بروتريبتيقوس» أرسطو معروفًا بين الناس في النصف الأخير من القرن الرابع قبل الميلاد.
مهما يكن الأمر فنحن لا نملك غير هذين النصين اللذَين يُذكَر فيهما كتاب أرسطو، وكلاهما لا يفيدنا بشيء عما يقوله فيه، ولقد مرت القرون وتوالت الأجيال منذ ذلك الحين إلى أن طرح العالم الألماني ج. برنايس (في كتاب صدر له في برلين سنة ١٨٦٣ عن محاورات أرسطو) مشكلة هذا الكتاب وتساءل عن هدفه ومضمونه، وبدأت عيون الباحثين تقتفي آثار الكتاب وتتلمَّس صداه في نصوص أرسطو الباقية من كتبه الضائعة، أو في نصوص القدماء الذين أخذوا عنوان كتابه وحاولوا تقليد أسلوبه وأفكاره، وظل الأمر في أخذ وردٍّ حتى بدد العالم الإنجليزي بايووتر٨ الظلام المحيط به وأثبت أن كتابًا بنفس العنوان ليامبلخيوس (أحد أتباع الأفلاطونية المُحدثة ٢٧٠–٣٣٠م) يضم جزءًا كبيرًا أُخِذ بنصه الحرفي من كتاب أرسطو، وتوالت محاولات العلماء من مختلف بلاد العالم لتفسير النص وتحقيق أسلوبه ومفرداته ومحتواه والتأكد من صحة نسبته لأرسطو، ويطول بنا القول لو حاولنا تتبع أسمائهم وتفاصيل الاختلافات التي دارت ولا تزال دائرة بينهم٩ إذ يكفينا في هذا التقديم أن نتناول الجوانب التاريخية العامة ونعرض لتحليل الكتاب ونشأته ومضمونه.
•••
أهدى أرسطو كتابه إلى أمير قبرصي مجهول هو «ثيميسون»، ويبدو أنه وجَّه بهذا الإهداء ضربة بارعة إلى خصومه وأثبت لهم أنه قد نزل إلى ساحة الميدان الذي ظل وقْفًا عليهم. ومع أن الظروف والأحوال السياسية في ذلك الحين ليس لها علاقة مباشرة بمضمون الكتاب، فإن الهدف الحقيقي من ورائه هو رد سهام هؤلاء الخصوم (وبخاصةٍ إيزوقراطيس١٠ صاحب خطبة «الأنتيدروزيس» التي انتقد فيها منهج التعليم والتربية في الأكاديمية، ورئيس إحدى المدرستين الفلسفيتين المتنافستين في أثينا) الذين هاجموا المعرفة النظرية، وأوحوا إلى الشباب أن الفلسفة — بوصفها معرفة خالصة — لا ضرورة لها ولا فائدة منها في الحياة العملية، وأن السعادة تكمن في استقامة السلوك والعمل الطيب وحده.
ولهذا فإن الدعوة البليغة التي يحملها الكتاب إلى التفلسف دعوة موجهة في الواقع إلى الشباب الأثيني المتزاحم على أبواب المدرستين المتنافستين، وهي حث له على حياة التأمل التي هي وحدها الحياة الخليقة بالإنسان.
•••
يبدأ أرسطو دعوته بالإشارة إلى أهمية الفلسفة والتساؤل عن الفضيلة والخير، ويبين أن كليهما لا يمكن أن يتحقق إلا عن طريق معرفة مطابقة له، فبغير هذه المعرفة يصبح امتلاك الخيرات الخارجية من ثروة وقوة وجاه خطرًا يُهدد الإنسان ويضره أكثر مما ينفعه. هذه المعرفة هي التي تضفي على تلك الخيرات قيمتها، وهي في الحقيقة تفوقها في القيمة؛ لأنها لم توجد لأجلها فحسب، وإنما هي قيمة في ذاتها، بل هي القيمة العليا التي تجعل لكل ما عداها قيمة؛ وبذلك ينتهي الغرض الأول بإثبات أن الفلسفة ممكنة.
ثم يشتبك المُعَلِّم الأَول في مجادلة الخصوم الذين يشكُّون في هذه النتيجة ويروِّجون بين الشباب أن الفلسفة لا ضرورة لها في الحياة العملية ولا جدوى منها، ويردُّ على هذا الاعتراض القديم المتجدد أبدًا بأن الفلسفة جديرة بالسعي إليها لذاتها؛ لأنها أسمى خير يمكن أن يبلغه الإنسان، ولما كانت الغاية الطبيعية للإنسان هي ممارسة العقل فإن الحياة العقلية المكرَّسة للتأمل والنظر هي مهمته الحقيقية وواجبه الأول، وبها يبلغ كماله ويجد سعادته، وإذا كان البعض يتهم هذه الحياة بأنها غير نافعة، فإن أرسطو يبين أنه لا يصح التقليل من قيمتها بالنسبة للمشرِّع والسياسي، وبهذا يثبت أن الفلسفة «نافعة».
ويتابع أرسطو طريقته في الحِجاج دفاعًا عن الفلسفة فيبين أن السعادة البشرية تقوم على فاعلية العقل، وأن التفلسف هو غاية الحياة الإنسانية بحكم طبيعتها نفسها، وأن هذه الحياة التي يهبها صاحبها للعقل هي أسمى لذة وأنقى فرح ممكن؛ لأن فاعلية العقل هي الخير الوحيد الذي لا يتوقف على غيره ولا يتطلب أي شروط خارجية، وهكذا تنتهي هذه الحجج إلى الفقرة الأخيرة (ب١١٠) التي ترتفع فيها موجة التحمس حتى تبلغ أسمى قمة، إن الفلسفة تعلو بالإنسان فوق الأرض وفوق الفناء، وتتيح له المشاركة في الخلود والألوهية، بل تجعله أشبه بإلهٍ بين بقية مخلوقات الله.
•••
هذه هي جملة الأفكار الأساسية في الكتاب، وهي تعبِّر بغير شك عن دفاع مخلص عن الفلسفة، يوشك في مفهومنا الحديث أن يكون نوعًا من الدعاية الأدبية الفلسفية، ولا بد أن القارئ قد أحس نغمته الخطابية التي تعلو في أجزائه (وخصوصًا في الفقرتين ب٤٣، ٤٤) إلى حد الصخب الذي يُخفِت صوت المنطق! ولكن هذا الصوت المرتفع في بعض الأحيان لا يستطيع أن يُخفي دفء العاطفة التي تسري فيه، وتجعل منه شهادة اعتراف صادقة سجَّل فيها الفيلسوف مَثَله الأعلى في الحياة، ومع أن أسلوب الكتاب يشفُّ عن روح الشباب ويختلف اختلافًا واضحًا عن أسلوب الكتب التعليمية المتأخِّرة التي يتميز بالموضوعية والجفاف، فإنه مع ذلك يعكس تفكير رجل ناضج ويدلُّ على خبرته بالحياة والناس وقدرته على الحجاج والإقناع، ولعل التحليل المتأني لمضمون الكتاب أن يؤكد هذا الإحساس ويمهد للإجابة عن السؤال الذي يطوف في أذهاننا عن زمن تأليفه وموقعه من كتابات المُعَلِّم الأَول وتطوره العقلي والروحي.








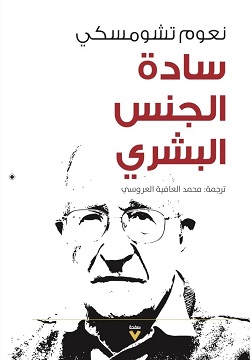



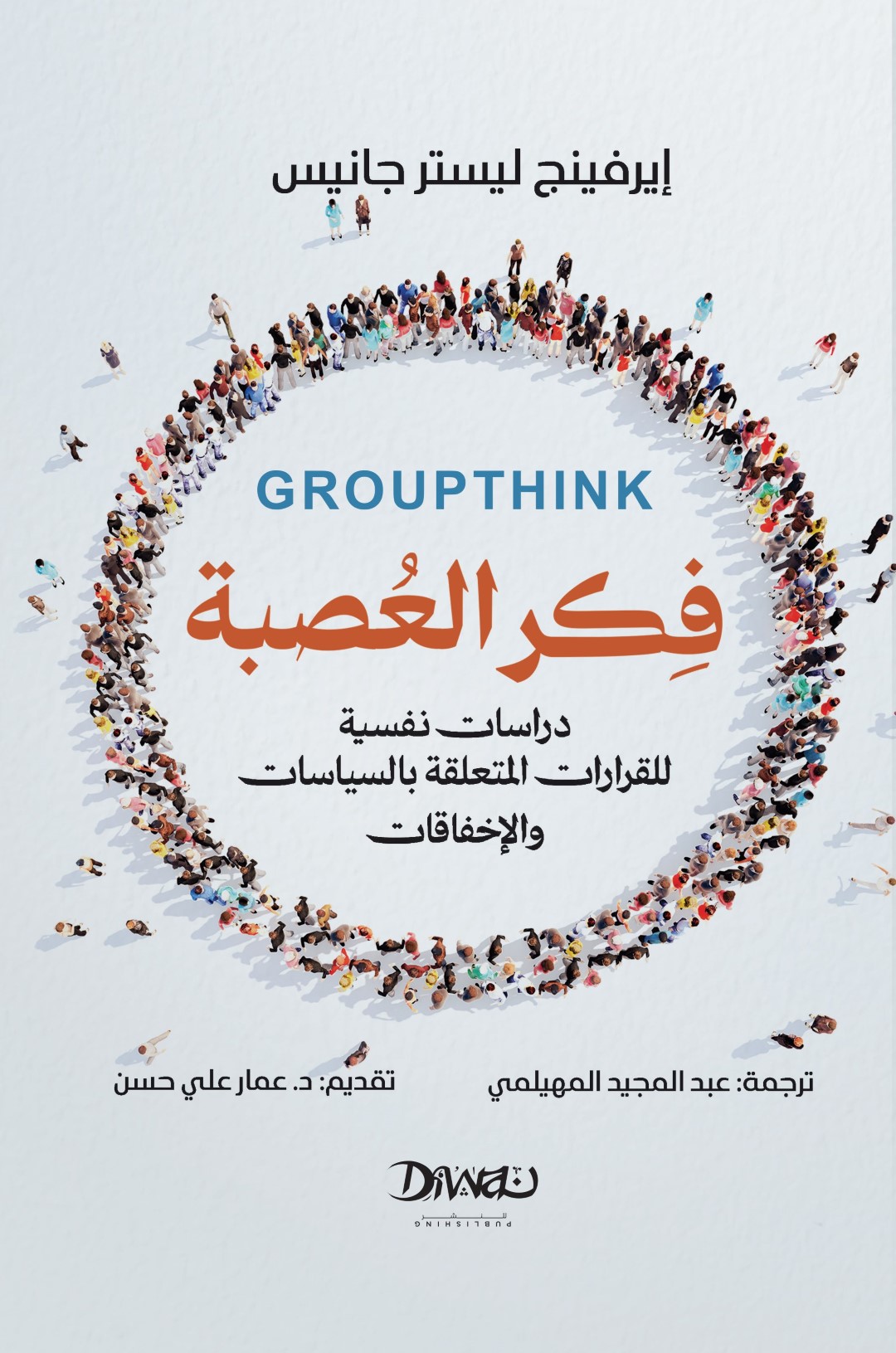





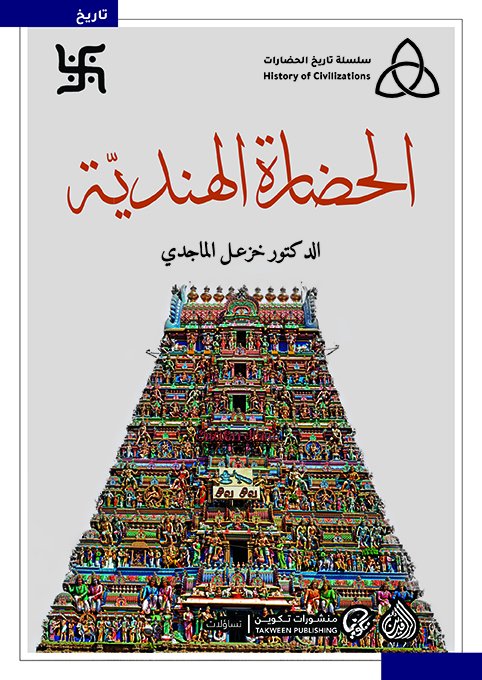
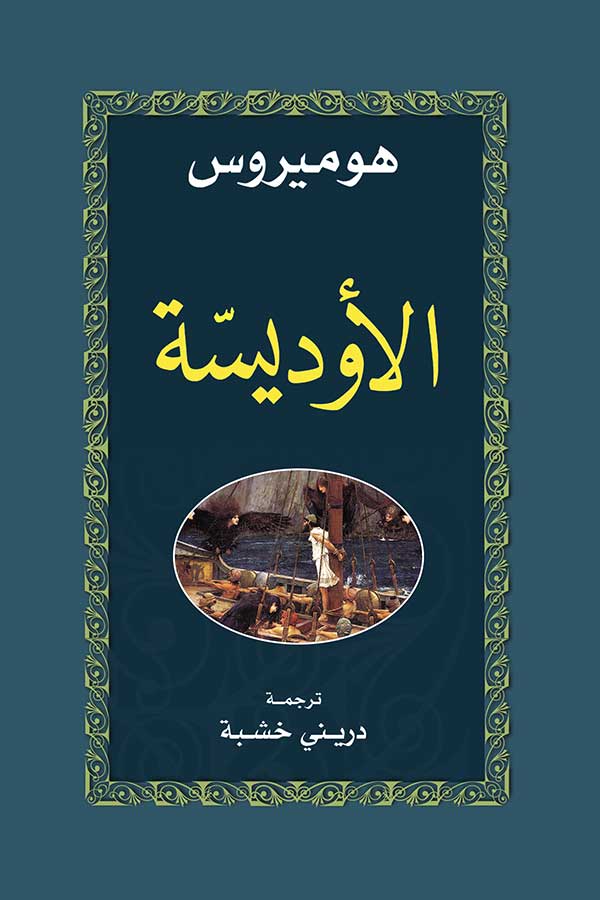
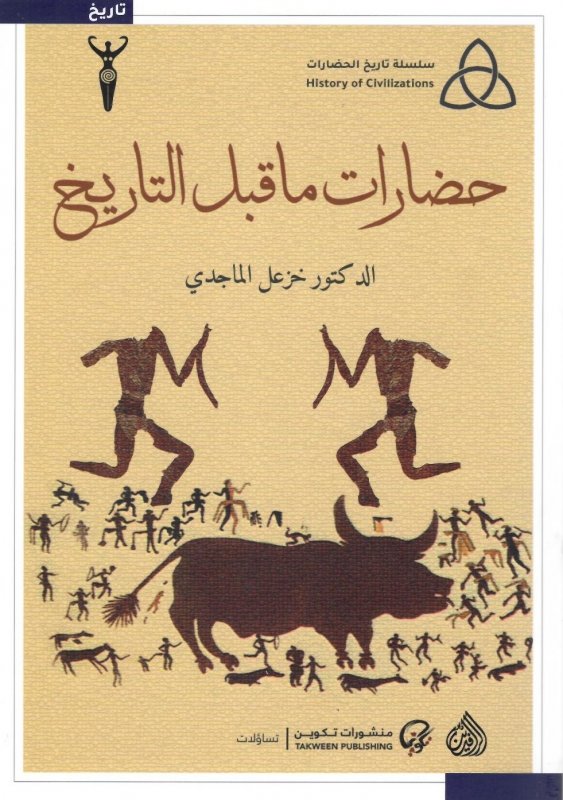
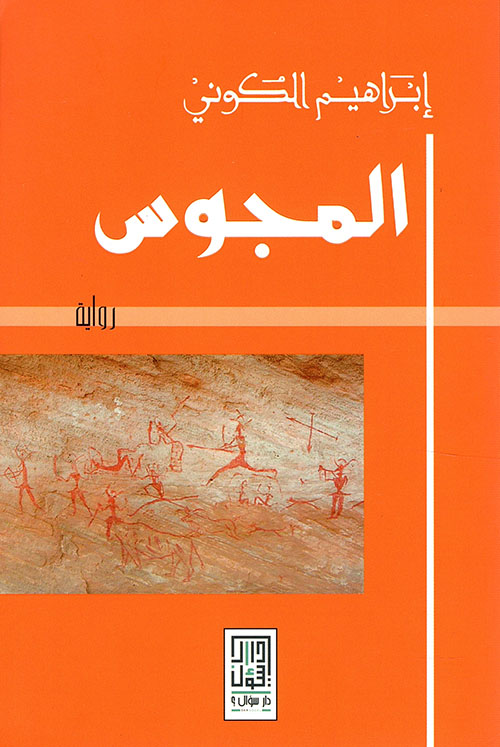
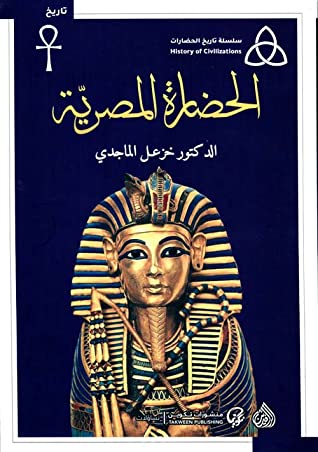

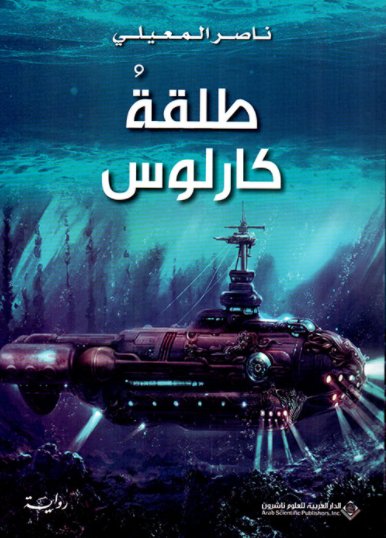
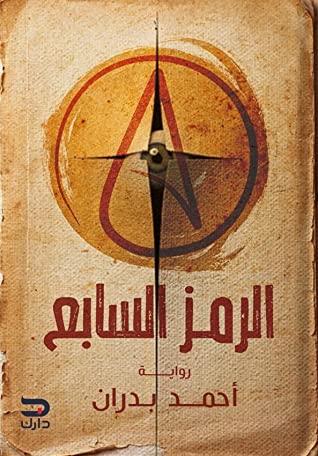

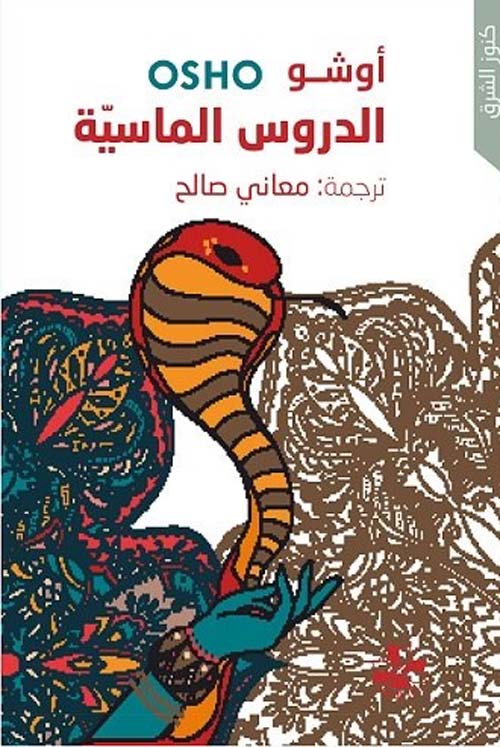

 الرئيسية
الرئيسية  المفضلة
المفضلة  الحقيبة
الحقيبة  فلتر
فلتر
لا يوجد مراجعات